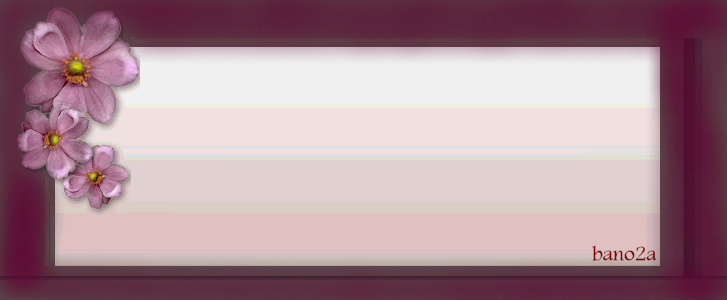الصواب والخطأ
كلّ شيء مرتبط بشكل حميمي بكلّ شيء آخر في الخليقة وبحيث يكون من غير الممكن التمييز بالكامل بوجود الواحد من الآخر. وتأثير الشيء على كلّ شيء آخر هو عالمي جداً بحيث لا شيء يمكننا أن نعتبره في عزلة. ذكرنا سابقاً بأنّ الكون يتفاعل للعمل الفردي. لذلك إن مسألة الصواب والخطأ هي مشكلة معقّدة جداً. إن الشخص الذي يعرف كلّ شيء عن كلّ شيء في الخليقة ويمكنه أن يقرّر تأثير أيّ عمل لأيّ فرد على أيّ طبقة من الوجود - سيكون هو وحده قادراً على القول الأكيد سواء كان ذلك العمل صحيحاً أو خاطئاُ.
إن الصواب هو الذي ينتج التأثير الجيد في كل مكان. ومن المؤكد أن الصواب والخطأ هي مصطلحات نسبية، ولا شيء في حقل الوجود النسبي يمكن القول عنه بأنه صواب بالمطلقة أو خاطئ بالمطلق، لكن، ورغم ذلك، يمكن الحكم على الصواب والخطأ فقط من التأثير الجيد أو السيئ. إذا أنتج الشيء تأثيراً جيداً نسبياً في كل مكان يمكن القول بأنه صواب.
لا يبدو بأن يكون الفكر البشري قاضياً ملائماً للصواب والخطأ، لأن الاستنتاج له محدودات، ولأن مجال رؤية العقل البشري محددة بالقياس مع الحقل الواسع وغير المحدود للتأثير الناتج عن الفعل في الكون أجمع.
إل أنه وفي حالة الوعي الكوني، وعندما يكسب العقل الفردي منزلة العقل الكوني، يمكن للفكر، بالطبع، أن يعتبر بأنه معياراً كافياً للصواب والخطأ؛ وهذا المعيار، وعلى أية حال، يكون مرتكز على مستوى الكينونة وليس على ذلك أو تلك من التفهم الفكري والتفكير والتمييز والاستنتاج. أولئك أصحاب الوعي المرتفع إلى مستوى الوعي الكوني ويعملون على المستويات الصواب للحياة من الطبيعي لا يقومون بما قد يكون خاطئ. هكذا، في مثل هذا الحالة، لا يطرأ السؤال عن معيار مناسب لحكم الصواب والخطأ.
إذاً يجب علينا أن نجد معياراً كافياً للصواب والخطأ للناس الذي لم يرتفع وعيهم إلى مستوى الوعي الكوني.
السلطة الدينيّة هي المعيار الأعلى للصواب والخطأ في الحقل النسبي للحياة. إن كلّ ما تقوله الكتب المقدّسة في بالمعنى الصحيح للفهم هو معيار الصواب والخطأ لكلّ الناس في كل مكان.
وبما أنه يوجد هناك كتب مقدّسة للعديد من الأديان المختلفة، قد نسأل السؤال ، أيّ منها يجب أن يكون السلطة الحاسمة للصواب والخطأ؟ في الجواب إلى هذا الاستفسار، نجد بأنه، وبالرغم من أن لغة الكتب المقدّسة تختلف، ودعاة الكتب المقدّسة كانوا مختلفين وأتوا في الأزمنة المختلفة في التأريخ الطويل للعالم، إلا أن الحقيقة الأساسية للكلّ هي ذاتها. ليس من الضروري الدخول بالتفاصيل الكبيرة لتأريخ الكتب المقدّسة، لكنّ ما هو معروف بأن الفيدا هي المخطوطات الأقدم. من السّهل إيجاد الحقيقة الضرورية والأساسية للحياة، المقترحة في الفيدا، في الكتب المقدّسة الأخرى التي ظهرت من وقت لآخر في الثقافات المختلفة لتوجيه قدر الإنسان ولتزويده بمعيار أصيل من الصواب والخطأ لمنفعة البشر. إنّ النقطة الجديرة بالاهتمام هي بأنّ الحقيقة الأساسية للحياة متضمنة في كلّ الأديان، ولذلك، يكفينا أن نلاحظ بأن الأتباع في أيّ دين قد يجدوا المعيار للصواب والخطأ طبقاً للمفهوم الصحيح للكتب المقدّسة لدينهم الخاص.
إن الإنسان الذي يقود حياة طبقاً للمواثيق الدينيّة في الدين الذي يتبع، سيجد حقيقة الحياة بالتأكيد ومن دون أيّ إرباك، ومن دون خلق أيّ إرباك بالدراسة المقارنة للأديان المختلفة.
قد يكون هذا خارج نطاق الموضوع الذي نتناوله، لكنّه في الوقت المناسب أن نسجّل بأن الناس، ومن دون أن يتعمقوا في حقائق أديانهم الخاصة، يحاولون أحياناً فهم حقائق الأديان المختلفة وفي القيام بذلك يصبحون أكثر إرباكاً. إذا كان رجلا واقفاً على منبسط ويقيس المستويات المختلفة للجبال، يمكنه أن يسجّل بدقّة الاختلاف في مستويات مرتفعات الجبال. أما إذا لم يكن كذلك ولم يضع نفسه على منبسط صلب قبل قياس المرتفعات المختلفة، بالتأكيد، سوف يقع بالإرباك، لأنه ليس لديه المرجعية ذات مستوى الثابت.
إذا كان الفرد لا يعيش حقيقة أي من الأديان، فيكون من غي الممكن للفرد أن يفهم أو يتعمّق في حكمة الأديان المختلفة، لأن الدين هو الشيء الذي سنعيشه – إنه ليس بفرضية للفهم والتحليل المنطقي. هو ليس في نطاق الميتافيزيقيا الذي يفحص بدقّة منزلة الحقيقة ويجيء إلى بعض الاستنتاجات التي ستفهم بشكل منطقي. الدين هو شيء عملي يجب إتباعه والعيش به و إدراك حقيقته بالعيش بالمبادئ الواردة في الكتب المقدّسة. إنّ حقائق الميتافيزيقيا، الفهم بشكل منطقي، يتم إدراكها في الحياة بأن يعيش الفرد النصائح الدينية في روتين الحياة اليومية. من الضروري أن يعيش الفرد دينه ويعرف الحقيقة منه بالاختبار. عندما يتم إدراك حقيقة الدين بالعيش بها، عندئذ لن يكون هناك أي أذى في قراءة نصوص الأديان الأخرى. هكذا سيجد الفرد بشكل أساسي بأن حقيقة الدين الذي يتبعه هي الحقيقة الأساسية لأديان الآخرين. هذه الحقائق هي المعيار الصحيح للصواب والخطأ.
إنّ حقل الكارما – العمل، هو حقل واسع وغير محدود ومعقد جداً بحيث من غير الممكن فهم المعيار الصحيح للصواب والخطأ بشكل منطقي. لكن، لا حاجة للقول، بأن الكتب المقدّسة هي المعيار الأوّل للصواب والخطأ. يتكلّم العديد من الناس عن المشاعر الداخلية. ويقولون، "أودّ فعل ذلك، لذا أنا أقوم به"
لكن "مشاعري" و"أعمالي" يمكن فقط أن تكون صحيحة أو خاطئة طبقاً لمعيار "وعيي"، ومن يعرف سواء كان "وعيي" صافياً بشكل مطلق أم لا؟
إن الحالة الصافية للوعي هي وحدها التي يمكنها أن تكون غير متحيّزة وعلى الصواب بشكل مطلق من أجل إلهامه، ويعود هذا الوعي فقط إلى حقل الوعي الكوني. إنّ الوعي العادي للإنسان يكون مدفوعاً بالعديد من الغايات الأنانية. لذلك، لا يستطيع الوعي المحجوب بالحوافز الأنانية إخراج الشعور أو الفكرة أو الكلمات أو العمل الذي يمكن أن تبريرها حقاً كعمل صحيح أو خاطئ. لكن، إذا كان حكم الفرد مستنداً على هذه السلطة الدينيّة، يكون له كلّ الحقّ في الشعور في داخل ذاته سواء كانت المشكلة التي يعالجها حقاً صحيحة أم لا.
إنه أمر حقيقي بأنه يجب على الفرد أن يشعر دائماً في داخل ذاته بالطبيعة الصحيحة أو الخاطئة للحالة، لكنّه يكون دائماً أكثر أماناً في فحص ذلك على ضوء المواثيق الدينيّة. أما الشعور الداخلي، وعلى أية حال، فلا يمكن أن يؤخذ كي يكون معياراً للصواب والخطأ. لكن علينا إعادة التأكيد بأنّ المعيار النهائي للصواب والخطأ في حقل الوجود النسبي والسلوك يجب أن يكون على أساس الكتب المقدّسة.
إذا لم يستطع الفرد الذي لا يملك معرفة الكتب المقدّسة، أن يقرّر لنفسه سواء كان الشيء، المنوي القيام به، صحيحاً أو خاطئاً، عليه أخذ المسألة إلى الناس المسنين أو الشيوخ في المجتمع للتقرير بها. إن للناس المسنين تجربة الحياة، لقد مرّوا بحلاوة ومرارة الوجود البشري وتعاملوا مع كلّ أنواع الناس وعاشوا كلّ مراحل حياة الإنسان. إنهم يعرفون ويفهمون بالخبرة لعبة الطبيعة وتأثير الصواب والخطأ أكثر من الشباب والأطفال. لقد مر عليه في الحياة أناسٌ مزدهرين ومفيدين لأنفسهم وإلى الآخرين نتيجة لأعمال الصواب، كما مرّ عليهم مئات الناس في المجتمع الذين أخذوا طريق السلوك الخاطئ - يعرضون صفات الخداع والوحشيّة والمكر والتلاعب. لقد رأوا بأنّ مثل هؤلاء الناس قد نالوا العقاب لأعمالهم الخاطئة وبأنّ ورثتهم المقربين لم يتمتّعوا بالحياة. إن كلّ هذه الأشياء قد مرّ بها هؤلاء الناس المسنين في المجتمع أو قد رأوها أمّا في حالتهم الخاصة أو في حياة العديد من الآخرين. إنهم قادرين أن يعطوا نصيحة إلى الجيل الأصغر على أساس تجربتهم الخاصة للحياة. هكذا يكون رأي الشيوخ الناحية الأخرى الموثوق بها للحسم بما هو الصواب أو الخطأ لأيّ مشكلة.
هناك معيار آخر للصواب والخطأ قد يكون الطريق الذي سلكه الرجال العظماء. يسجّل التأريخ كل الأعمال الناجحة وحالات الفشل للرجال العظماء، وكل أعمال الخير والشر، في الأزمنة المختلفة في الأراضي المختلفة. إن الطرق التي اتبعوها، والطريقة العملية للحياة التي عاشوها، والنتائج التي حصلوا عليها من طريقة الحياة المعيّنة يمكن أن تكون أيضاً معياراً آخراً يمكن من خلاله تحديد طرق حياة الصواب والخطأ.
وبمعزل عن هذه المستويات المختلفة لمعايير الصواب والخطأ، هناك معرفة عامة تقول بأنه من الصواب أن لا نؤذي أي واحد وهي الخطأ أن نؤدي. من الصواب رؤية حسنات الآخرين، وهو خاطئ رؤية السيئات في أي احد. من الصواب محبّة الناس، ومن الخطأ كراهيتهم. من الصواب احترام الناس للحسنة في أنفسهم، وهو الخطأ توبيخهم لعيوبهم وسلوكهم السيئ. من صواب نصح الإنسان إذا كان يقوم بما هو خاطئ، ومن الخطأ أن لا ننصحه للقيام بما هو حسن. من الصواب القيام بالأشياء التي ستساعد الفاعل وتساعد الآخرين، ومن الخطأ القيام بالأشياء التي ستؤذي الآخرين. من الصواب قول الحقيقة، لكنّه من الخطأ التكلم بكلمات تؤذي الآخرين، حتى ولو كانت الحقيقة. من الصواب أن نعامل الآخرين بالحسنة، ومن الخطأ نكون بغضين إلى أي أحد. هذا التمييز من الصواب والخطأ هو لمساعد الفرد ولمساعدة كلّ الخليقة، لأن، وكما رأينا في الجزء عن "الحياة الفردية والكونية" يتفاعل الكون بأكمله إلى العمل الفردي. لذلك، تقع المسؤولية الكبيرة للصواب والخطأ على الفرد بنفسه على مستوى وعيه.
سيكون أمراً جيداً للفحص بدقّة قيمة النقاط المذكورة في الفقرة السابقة. لقد ذكرنا بأنّه من الصواب أن لا نؤذي أي أحد ومن الخطأ إيذاء الآخرين. رأينا بأنّ الفعل وردّة الفعل متساويين. إذا صفع شخص طفلاً بغضب، يكون قد صفع أو ضرب الكون بأسره وأنتج جوّاً من البكاء والكراهية والمعاناة والنزاع - ليس فقط في الطفل لكن في الكون بأسره. ربما يكون تأثير الوحشيّة والكراهية والنزاع والمعاناة أعظم بكثير في الطفل، وضعيف جداً في البيئة المحيطة، لكن، مع ذلك، فالتأثير موجود. إذا قامت أغلبية الناس في العالم بصفع شخص ما كلّ يوم وخلق الجوّ ذاته، من المؤكد أن كثافة تأثير النزاع والمعاناة والحزن والكراهية ستكون بما فيه الكفاية كي تبدأ بإظهار تأثيرها في العالم.
هكذا، ومن الضروري جداً أن لا يؤذي الفرد أحداً. هذا أقلّ ما يمكن أن يفعله الإنسان؛ أما أفضل شيء يمكنه القيام به هو إنتاج تأثير الانسجام والحسنة والعطف والمساعدة.
رأينا في الجزء عن "الكارما و الكينونة" بأنّ عمل الفرد يعود إليه من كلّ حقول الخليقة، ولذلك، إذا أساء الفرد إلى شخص ما، سيعود ذلك الأذى إليه من الطبقات غير المعدودة للطبيعة ولفترات غير معدودة من الوقت، ولذلك من الأفضل إتباع سياسة عدم الإساءة إلى أيّ أحد كي لا نتعرض للأذية من قبل أي أحد، ولنقوم بالحسنة بالقدر الممكن إلى الآخرين، كي تعود إلينا هذه الحسنات بحدها الأقصى من الحقل الخليقة بأكمله.
يقال بأنه يجب علينا محبة الآخرين لحسناتهم، وبأنّه من الخطأ توبيخ أي أحد لأيّ ضعف فيه أو لسلوكه السيئ مع الآخرين. إنها نقطة هامّة جداً في أن نرى الحسنة في الآخرين. في واقع الأمر، لا يمكن للإنسان أن يكون جيداً بالكامل أو سيئاً بالكامل، لأن الحياة البشرية هي نتيجة لخليط من الجيد والسيئ. لو كان الإنسان جيداً فقط، كان يمكن أن يكون في عالم الملائكة حيث أنّ هناك لا معاناة وحيث يوجد فقط السعادة والبهجة. وهكذا وفي حياة الإنسان يجد الفرد مزيجاً من السعادة والمعاناة. هذا يظهر بأنّ الوجود البشري نتيجة بعض الأعمال الحسنة وبعض الأعمال السيئة. كلّ شخص فيه بعض الحسنات وفيه بعض السيئات، وإذا احترمنا الفرد لحسناته، نكون قد رأينا الحسنات فيه أولاً. عندما نرى الحسنات فيه ننال انعكاس الحسنات. وإذا، ومن الناحية الأخرى، حاول الفرد رؤية السيئات في شخص ما، يستلم انعكاس السيئات التي ستلوّث عقله وقلبه. إذا رأى الفرد نقاطاً جيدة في شخص ما، من الطبيعي أن تنعكس عليه بعض النقاط الجيدة. إن العمل الحقيق لرؤية الأشياء الجيدة في شخص ما يعكس هذه الأشياء الجيدة على العقل وقلب الرائي ولذلك يكسب الرائي شيء جيدا من الأشياء الجيدة التي يراها في الرجل الآخر. هذه مهارة عظيمة في الحياة، لرؤية الحسنة في الآخرين. كلّ شخص لديه بعض الحسنات.
يوجد رواية في الهند حول رجل متعلّم يعش في مدينة اسمها بانارس، إنها مقرّ التعليم في شمال الهند. يحترم هذا الرجل الحكيم الآخرين دائماً، ولم يستطع أي أحد أن يسمعه يتكلم بالسوء عن أي واحد. كانوا الناس جميعاً معجّبون بأنّ هذا الرجل يمكنه أن يرى الحسنة في كلّ شيء في كلّ حقول الحياة والخليقة. إنه يحترم الأشياء فقط، ولا يسمح لعقله وقلب أن يتلوثا من رؤية أيّ شيء سيئ في أي أحد. في أحد الأيام اعتقد رجل مؤذي بأنّه قد يجد الشّيء الذي سيكون كله سيئ ويضعه أمام الرجل الحكيم لرؤية ما يمكنه أن يجد فيه من حسنة. وجد كلباً ميتاً ونتناً مرمياً في الشارع، ودعا الرجل المتعلّم على العشاء في بيته. (في الهند يدعو الناس عادة هؤلاء الرجال الحكماء والقديسين إلى بيوتهم في الأعياد ويقدمون لهم وجبات الطعام). أخذ الرجل المتعلّم على طول الشارع الذي فيه رأى الكلب النتن. وكانت الرائحة الكريهة تفح منه، وكان منظره بغيضاً للرؤية. عندما دنوا منه، بدأ صانع الإيذاء بالتهويل والتذمر قائلاً: "ما هذا الشيء المثير للاشمئزاز الذي نصادفه في الشارع". لكن الرجل الحكيم فاجأه في القول: "لكن أنظر إلى الأسنان الكلب البيضاء النظيفة." وفيما هو يشرح عن وهج البياض المشع من أسنان الكلب، سقط الرجل الآخر على أقدام الرجل الحكيم، فقال الرجل الحكيم، "إذا كنا لا نريد إهماله، سنجد بعض الحسنات كلّ شيء في ملكوت الله." إن هذا العالم هو حديقة الله القدير والذي خلق فيها تشكيلة من الزهور. قد تلتقط واحدة تحبّها، لكنّك ليس لك حقّ في القول بأن الزهرة لآخرة هي سيئة. حتى إذا كنت لا تحبّ تلك الزهرة، الله خلقها لشخص آخر له المذاق الذي به سيكون سعيداً في الحصول عليها. لا تنفرد بمذاقك وحده، لكن احترم التنوع العظيم في حديقة الله.
يقال بأنّه من الصواب إعطاء النصيحة للإنسان لفعل الخير والحسنة، التي ستساعده وتساعد الآخرين. كما يقال أيضا بأنّه من الخطأ عدم إعطاء النصيحة لإنسان للصواب والخطأ، إذا كنا نعرف ذلك. هذه نقطة هامّة جداً في العالم اليوم.
هناك شعور عامّ سائد في المجتمع المتحضّر اليوم بأنّهم يجب أن لا ينتهكوا المشاعر والمرغوبات والمكروهات الناس الآخرين. هذا راح هذا الأمر بعيداً إلى حد خلق اعتقاد واسع الانتشار بأنه حتى الأطفال لا يجب أن يخبروا ما عليه أن يفعلوا. ويقال بأنّه لا يجب إخبارهم ما هو الصواب وما هو الخطأ، لا يجب أن يتم توجيههم لفعل الخير والابتعاد عن فعل الشر. من المحتمل أن يكون هذا قد أتى من حقل علم النفس، الذي يظهر مبدأ النمو بالحرية. لكنّه من سوء الحظ وبشكل أساسي أن يُترك هذا المعيار من الحرية يحجب كلّ الأساسيات الرئيسية لتقدّم الحياة. إذا كان الفرد لا يعرف بأنّ ما يقوم به سيؤذيه في الحاضر أو في المستقبل، فيجب على من يمتلك تلك المعرفة أن يخبره ذلك من باب المحبة والعطف واللطف والمساعدة، بأن هذا العمل ليس صواب.
إذا أقدم الطفل على التقاط قطعة فحم مشتعلة، معتقداً بأنّها لعبة لامعة رائعة متروكة هناك من أجله للتمتّع بها، يكون من الصواب أن يمنع الوالدين الطفل من التقاط الجمرة، حتى وإن استاء الطفل لعدم السماح له للاندفاع إلى النار. إن مثل هذه الحرية هي سخيفة وخطرة لتطوير الإنسان ولتطوير الجيل الأصغر ولتطوير الناس الأبرياء والجاهلين لهذه الحكمة وتجربة الحياة. إن مسؤولية الشيوخ والناس المسنين لنصح الصغار. حتى ولو استاء الشباب من توجيهاتهم ولم يطيعوهم، إنه لأمر حسن في إخبارهم. سيكتشفون بأنفسهم نتيجة عدم طاعة شيوخهم، لكن إذا لم يتكلّم الشيوخ مطلقاً ويتركون الطفل للاكتشاف بنفسه ما كان خاطئاً، يكونون قد أهدروا وقت الطفل وكانوا قاسيين معه. إن معرفتهم لما هو غير صحيح للطفل وغير مساعد لحياته، دون أن يقوموا بنهيه عن متابعة ما يقوم به، يكون ذلك موقفاً خاطئاً جداً في الوالدين لاعتقادهم بأن ما يقولونه يجب أن ينفذه الطفل، لكن إذا رأوا بانه من الممكن أن يستاء الطفل من نصيحتهم يسكتون ولا ينبهون الطفل. إنها ليست عاطفة؛ وليست حبّاً؛ وليست صحيحاً للوالدين أن يأخذوا هذا الموقف. إنّ الطفل هو صغير وعديم الخبرة وليس له تلك الرؤية الواسعة وتجربة الحياة. ومع إعطاء كلّ الحرية للطفل يجب على الوالدين أن يخبروه بمحبة وعاطفة بأنّ هذا خطأ وذلك صواب. أما إذا استاء منهم، لا يجب على الوالدين أن يلحّوا كثيراً، لأنه إذا لم يطع وفعل ذلك الشيء، من الطبيعي سيصادف التجربة التي ستخبره بأنّ أباه أو أمّه كانا على صواب. هذه هي الطريقة لتنمية ميل الطفل في الطاعة والتصرّف طبقاً للرغبات ومشاعر الوالدين. إذا كان الطفل مستاءً ولا يطيع، يكون الوالدين على الأقل قد قاموا بواجبهم في إعلام الطفل. ومن ثم، يفرض عليه الواجب أن يبلغوا الطفل بالأعمال الصواب من قبل أصدقائهم، ومعلميهم وجيرانهم - من شخص ما يحبّه الطفل حقاً ويطيعه. من واجب الوالدين أن يروا بأن الطفل يربّي على كلّ مستويات الحكمة والحسنة في الحياة. إنّ المسؤولية لعدم إخبار الطفل بما هو صواب وما هو خطأ وعدم محاولة تغيير طريقه إذا كان يسير في مسك خاطئ تكم على الوالدين. الأطفال مثل الزهور في حديقة الله، وهم يجب أن يتغذّوا. إنهم لا يعرفون بأنفسهم أيّ طريق هي الأفضل لهم لسلوكها. إنه من واجب الوالدين أن يفسحوا المجال لهم في طريق خالية من المعاناة. إنه أيضاً جزء دور الوالدين في معاقبة طفل إذا لم يطع ويقول بما هو خاطئ، لكن يجب أن يعاقبوا الأطفال بكلّ الحبّ.
إن الواجب الأوّل للوالدين أن يروا بأنّ أطفالهم ينشئون على معايير بنّاءة من الحكمة والعمل الصالح في المجتمع. أما والميل الحديث لوضع مصير الأطفال بالكامل في أيديهم الخاصة فهو ضارٌ جداً. ويؤدّي فقط إلى النمو الجاهل للجيل الأصغر.
هناك مدارس في بعض البلدان تدعو للحرية الكاملة للأطفال، لكن هذه المدارس هي وبشكل أساسي نتيجة لسياسة تم تبنيها من قبل أولئك الذين كان غرضه الوحيد في جعل الأمة ضعيفة والذين بالتالي يريد أن ينمو الجيل الأصغر من دون تقاليد ومن دون أيّ قاعدة مثقّفة في الحياة، ومجردة من قوة الشخصية. إن هذا العمل هو قاسٍ وضارّ جداً لمصالح المجتمع البشري بعدم توجيه وتشكيل أسلوب السلوك والتفكير والعمل للجيل الأصغر من خلال الحبّ والانضباط بشكل متزامن. وقد زحفت هذه الفكرة ذاتها إلى المدارس الأطفال الصغار جداً حيث يحرّم المعلمون من معاقبة الأطفال. وكانت النتيجة في نمو جنوح الطفل ما يؤدّي إلى جنوح الأحدث وإلى الحيرة الكبير والشك في عقول الأطفال حول الصواب والخطأ في العمل أو الفكر أو نمط السلوك. لا يفهم شاب اليوم وليس عندهم أيّ إدراك لمعايير السلوك المحترم التقليدي لوطنه. إن هذا هو فقط النمو البرّي للعقول المتخلّفة من دون خلفية لأيّ ثقافة تقليدية.
إنه لشيء مخجل ذلك التعليم في العديد من البلدان التي تأثرت بمثل هذه الأسلوب، وتحت شعار النمو بالحرية. كانت هناك نتائج مشؤومة من جراء عدم تشكيل وتوجيه أنماط التفكير والسلوك في حياة الجيل الأصغر.
يعود الأمر لرجال الدولة الوطنيين والناس الأذكياء للبلدان المختلفة، للنظر في النتائج الكارثية من مثل هذا نمط للتعليم، الذي يتم ارتكابه تحت عنوان علم النفس للطفل، وللقيام بتعديل طرق التعليم وتنشئة الأطفال. يجب أن ينال الأطفال الحب كما يجب أن ينالوا العقاب. يجب أن ينالوا الحبّ لنمو حياتهم، ويجب أن يعاقبوا إذا هم خاطئون. إن هذا فقط لمساعدتهم للنجاح في الحياة على كلّ المستويات. لكلّ بلد تقليده الخاصة، ولكل شعب له أديانه وأيمانهم، وهكذا يجب أن يتم إعطاء الأطفال الفهم لتقليدهم ودينهم وإيمانهم.
إنه لخطأ عظيم من ناحية المربين التربويين اليوم في إيجاد الأعذار تحت شعار الديمقراطية بمنع إعطاء أيّ مفاهيم تقليدية إلى الأطفال. تنشأ مثل هذه الأفكار بالضرورة من أولئك الذين لديهم الدافع في إضعاف الشعب وسرقة الناس من تقاليدهم الوطنية وكرامتهم. واستئصال تقاليد المجتمع هو الضرر الأكبر الذي يمكن أن يحدث إلى خير الأمة. إن المجتمع الخالي من التقليد ليس له استقرار أو قوّة أساسي خاصة به؛ يصبح مثل ورقة متروكة تحت رحمة الريح، يجرفها في أيّ اتجاه من دون أيّ استقرار وقاعدة خاصة بها.
تحت شعار التعليم الحديث، تترك مجتمعات العديد من البلدان التقليد القديم. أما النتيجة فهي في النمو البرّي للناس الكافرين والخاليين من أصالة التقليد والذين تتواجد مجتمعاتهم فقط على المستوى السطحي والخارجي للحياة.
من دون منفعة الثقافة المثبتة، من المهم جداً بأن تبادل الحكمة يجب أن يتواجد بين الشباب والجيل الناضج. وإنه أمر صحيح في إخبار الناس بالشّيء الجيد وعدم إخبارهم للقيام بشّيء خاطئ، من الضروري قول الأشياء الصحيحة وإبداء المشاعر الصحيحة على مستوى جليل وبطريقة معتدلة. إذا لم يتم التعبير عن الصواب والخطأ من قبل الشخص الذي يملك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، يكون مذنباً لعدم مشاركته بما يملك مع الآخرين.
يقال بأنّه من الصواب قول الحقيقة، لكنّه من الخطأ التكلم بكلمات ذات طبيعة مؤذية أو بأسلوب مؤذي للآخرين. إن التكلّم بأي كلمات ضارّة من قبل الفرد سيكون لها ارتداد مؤكد على ذلك الفرد. إنّ الأذى المنتشر في الكون كله سيعود إلى الفاعل من العديد من الجوانب. يجب أن يكون الكلام دائماً على مستوى عالٍ جداً من المحبّة والإعجاب والتسامح للآخرين.
إذا كان تعبير الحقيقة يؤذي البيئة المحيطة والجوّ، لا يجب أن ينطق به. إنّ الحقيقة هي لتمجيد خليقة الله، ولذلك، يجب أن يكون التعبير عنها على ذلك المستوى العالي الذي هو مستوى الحقيقة. إنه ليس بالشيء الحسن أن تكون غير ساراً، حتى في تعبير الحقيقة لأن الحقيقة هي نور الله؛ إنها الأكثر قيمة وصفاً، ولا يجب أن تهبط إلى مستوى الأذى أو الكراهية في الحياة. بل يجب أن تبقي على المستوى العالي لنقاوة الوعي، المستوى العالي من نقاوة الحبّ والتقوى.
إنّ الحقل الكامل لحياة الفرد هو حقل الأخذ والرد. إنه السلوك المتبادل الذي يساعد دائماً لتحمّل حياة الناس ولمساعدة تطورهم. لذلك إن سلوكهم صحيح دائماً أولئك الذين يعرفون الحقيقة. ليس هناك فعل أعظم من الصدقة في تزويد الإنسان بشيء يرفعه مباشرة ويساعد تطوره. هذا لمصلحة كلا الطرفين.
لن يكون هناك فضيلة أعظم من إيجاد الوسيلة للبشر للارتقاء بشكل طبيعي إلى حالة الحياة حيث يكون مجرى حياتهم يتدفق فقط في القناة الصحيحة. يجب على كلّ الفضائل أن تتشرّب من الطبيعة الحقيقية للعقل، لكي يتم العيش بها بشكل صحيح في الحياة، ولكي يتم العيش بكل ما هو صواب وبشكل طبيعي. لهذا، وكما رأينا في "فنّ السلوك" إن الطريق المباشر والوحيد هو في جعل تقنية التأمل التجاوزي متوفرة لكلّ الناس.
هناك جهد كبير يتوجب القيام به من قبل الناس المسؤولين في كل مكان لجعل تقنية التأمل التجاوزي تعطى إلى كلّ الشباب، لكي يرتفع وعي الناس. إن الطاقة الأكبر والوضوح ونقاوة العقل وكشف الإمكانيات العقلية هي متوفر إلى الجميع. إذا تم تعليم التأمل التجاوزي إلى جميع الطلاب، سينمون في الإحساس الصحيح للقيم ويكونوا مواطنين لبلادهم متمتعين برؤية واسعة للحياة وبإحساس حقيقي وصحيح من الحكم في الصواب والخطأ.
منقـــ ـــ ــــــــــــووول ,,,>,,,,<,,, زيـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ــزٌوُ